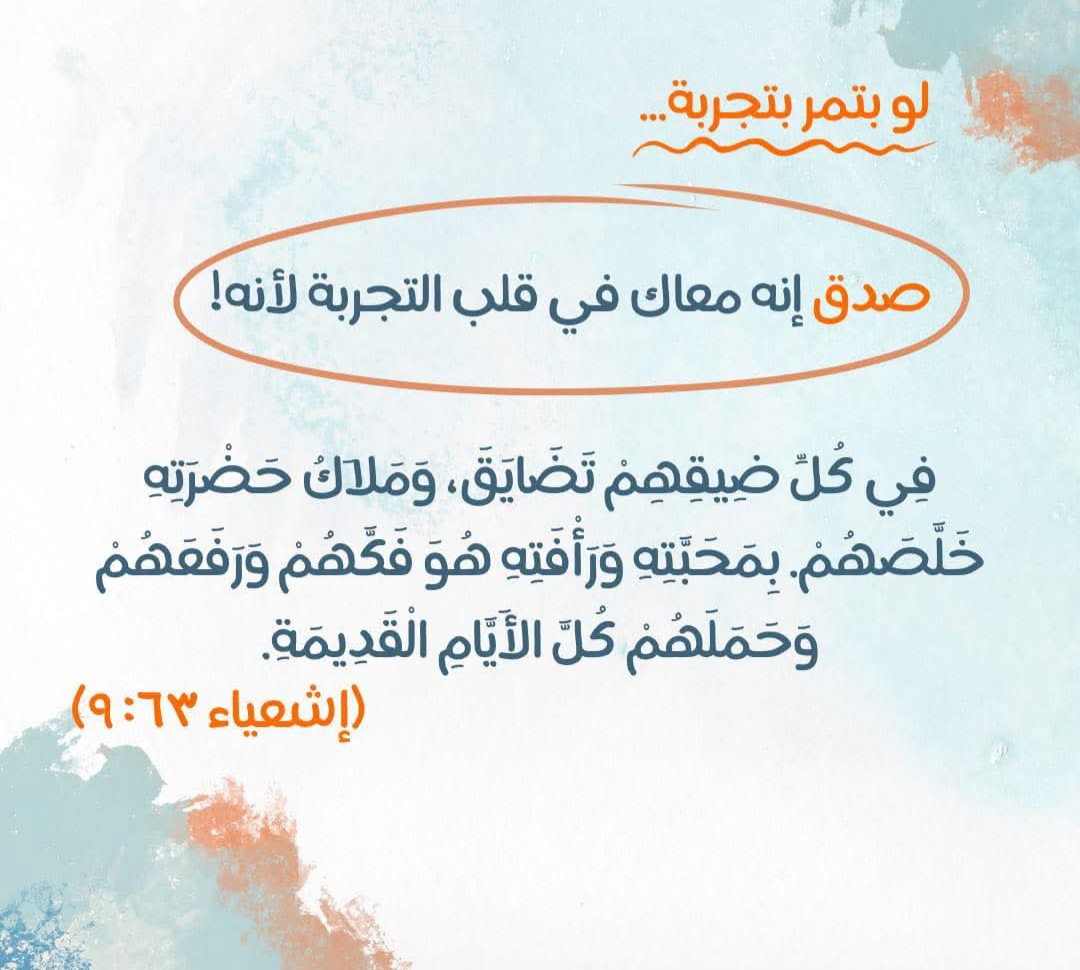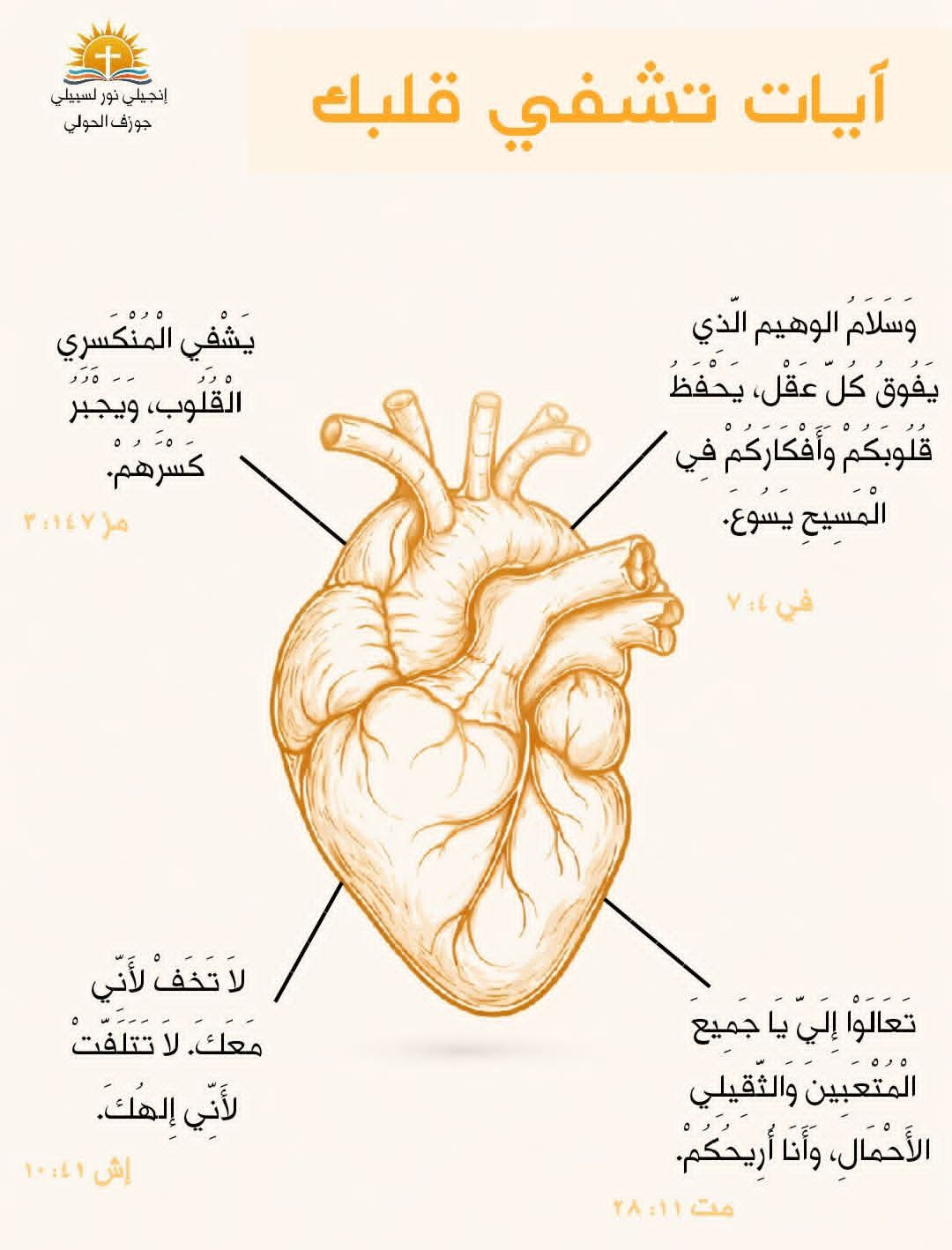"حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلَهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ»."
(مت 4: 10).
في أحد التجربة نتعلم انه لا تفاوض مع الشيطان !
 مبدأ روحي اعطاه لنا الرب يسوع
مبدأ روحي اعطاه لنا الرب يسوع
و هو سرعة رفض الشر و عدم التفاوض مع الافكار الشريرة
 الافكار الشريرة في اولها بتكون ضعيفة و إرادتنا بتكون قوية نقدر نرفضها بسهولة
الافكار الشريرة في اولها بتكون ضعيفة و إرادتنا بتكون قوية نقدر نرفضها بسهولة 
لكن لو تفاوضنا معاها تبدأ الارادة تضعف و الافكار تأخد سلطان علينا و تسقطنا
 فلننتهر الشيطان بإسم يسوع و لا نتفاوض معه و نستخدم كلمة الله كسلاح قوي في حروبنا الروحية كما علمنا السيد المسيح في التجربة علي الجبل
فلننتهر الشيطان بإسم يسوع و لا نتفاوض معه و نستخدم كلمة الله كسلاح قوي في حروبنا الروحية كما علمنا السيد المسيح في التجربة علي الجبل
و الله قادر ان يعطينا النصرة و الغلبة علي تجارب ابليس

(مت 4: 10).
في أحد التجربة نتعلم انه لا تفاوض مع الشيطان !
و هو سرعة رفض الشر و عدم التفاوض مع الافكار الشريرة
لكن لو تفاوضنا معاها تبدأ الارادة تضعف و الافكار تأخد سلطان علينا و تسقطنا
و الله قادر ان يعطينا النصرة و الغلبة علي تجارب ابليس